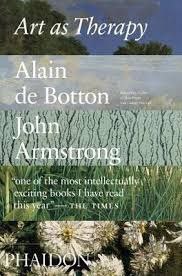الفن كعلاج كيف يساعدنا الجمال على التعافي؟
منذ قرون طويلة، وقف الإنسان أمام اللوحات والمنحوتات كمن يقف أمام مرآةٍ يرى فيها ذاته، لكنّه لم يكن يدرك تمامًا أن هذه المرآة يمكن أن تُصلح ما انكسر في داخله. في كتابهما المشترك «الفن كعلاج» (Art as Therapy)، يعيد الفيلسوف والكاتب ألان دو بوتون والمؤرخ الفني جون آرمسترونغ تعريف وظيفة الفن في حياتنا اليومية، مقترحين أن للفن دورًا يتجاوز الزينة والمتعة البصرية، ليصبح وسيلةً للعلاج النفسي، ومصدراً للتوازن الروحي، وطريقاً لفهم الذات.
الفن ليس ترفاً... بل حاجة إنسانية:
يرى دو بوتون وآرمسترونغ أن الفن وُجد ليؤدّي وظيفة علاجية حقيقية، وإن لم يكن ذلك في الإطار الطبي الصارم. فكما يحتاج الجسد إلى الغذاء والهواء، تحتاج النفس إلى الجمال والحوار الوجداني العقلي الروحي المختلف كي تبقى حيّة. الفن، في نظرهما، ليس ترفاً ولا تزييناً للفراغ، بل ضرورة تُعيد للإنسان قدرته على التأمل، والتوازن، والتواصل مع ما هو جوهري في حياته.
لقد تعوّدنا على زيارة المتاحف والمعارض لنرى ما أنجزه الفنانون عبر العصور، لكن المؤلفين يقترحان أن نعيد التفكير في هذا الطقس الثقافي. فبدلاً من السؤال التقليدي: «من رسم هذه اللوحة؟ ومتى؟»، يدعواننا إلى أن نسأل: «ماذا يمكن أن تقدّمه هذه اللوحة لي أنا؟ ماذا تُخبرني عن حزني، عن وحدتي، عن خوفي من الفقد؟».
بهذه الطريقة، يصبح الفن مساحةً للحوار بين الإنسان وعالمه الداخلي. فكل عمل فني يمكن أن يُحدث صدى فينا، يذكّرنا بشيء فقدناه، أو يُشعل فينا بصيص أملٍ في مواجهة ما هو قاسٍ وغامض في الحياة.
ألان دو بوتون وجون آرمسترونغ: الفلسفة في خدمة الحياة
ينتمي ألان دو بوتون إلى فئة المفكرين الذين يؤمنون بأن الفلسفة يجب أن تكون قريبة من الناس، وأن تنزل من برجها الأكاديمي إلى الشارع والمقهى وغرفة المعيشة. اشتهر بكتبه التي تربط الفكر بالحياة اليومية مثل قلق المكانة وكيف يمكن لبروست أن يغيّر حياتك. وهو مؤسس مشروع «مدرسة الحياة» (The School of Life) الذي يسعى إلى تعليم مهارات العيش العاطفي والفكري من خلال الأدب والفن والفلسفة.
أما جون آرمسترونغ فهو فيلسوف ومؤرخ فني بريطاني متخصّص في علم الجماليات (Aesthetics)، وله مؤلفات في فلسفة الفن والتربية الجمالية. يجمعه مع دو بوتون إيمانٌ بأن الفن ليس مجالاً نخبويًا مغلقًا، بل وسيلة لفهم النفس والمجتمع والوجود.
تعاونهما في هذا الكتاب جاء نتيجة رؤية مشتركة: أن الفن، كما يقولان، «ينبع من الحياة ويعود إليها». فهو يلتقط جوهر التجارب الإنسانية، ثم يعيد تقديمها لنا في شكلٍ بصري يجعلنا نرى ما لم نكن نجرؤ على النظر إليه من قبل.
سبع وظائف علاجية للفن:
في «الفن كعلاج» يقدّم الكاتبان ما يشبه “خريطة علاجية للجمال”، حيث يحددان سبع وظائف أساسية يمكن للفن أن يؤديها في حياة الإنسان:
1. التذكير بما يهمّ: الفن يوقظ فينا القيم التي نغفل عنها وسط ضجيج الحياة، يذكّرنا بالحب، بالكرم، بالسكينة والذكريات والمشاعر السعيدة، وبأن ما نحتاجه غالبًا ليس المزيد من المال، بل مزيدًا من الوعي.
2. منح الأمل: حين نتأمل لوحةً مضيئة أو مشهدًا من الطبيعة مصورًا بعذوبة، نستعيد قدرتنا على الحلم، ونشعر أن الجمال لا يزال ممكنًا حتى وسط الخراب.
3. تلطيف الحزن: الفن لا يهرب من الألم، بل يمنحه شكلاً ومعنى، فيساعدنا على قبول الحزن لا كمأساة، بل كتجربة إنسانية تُكملنا.
4. إعادة التوازن: أمام فوضى الحياة، يتيح لنا الفن لحظة انسجامٍ داخلي، إذ يعيد ترتيب أفكارنا ومشاعرنا وتوافقنا النفسي، كما لو أنه ينسّق الفوضى في لوحةٍ منسجمة.
5. فهم الذات: الفن مرآة للوعي، يدفعنا لطرح الأسئلة عن ذواتنا: لماذا أحب هذا اللون، هذا الشكل، هذا التكوين، هذا الموضوع؟ لماذا تلمسني هذه الصورة؟ تلك الأسئلة تفتح أبوابًا نحو معرفة النفس، وارتباطها بالبيئة والتاريخ والناس.
6. النمو الشخصي: عبر الاحتكاك بالجمال المختلف، نتعلّم التسامح والتعاطف مع الآخرين ومع أنفسنا، ونتحرّر من ضيق التجربة الفردية بالتعرف على تجارب الآخرين.
7. تجديد النظر في المألوف: الفن يجعلنا نرى العالم من جديد؛ الكرسي الذي نجلس عليه، أو وجه من نحب، أو حتى البيئة من حولنا والسماء من فوقنا، تصبح أكثر عمقًا حين يمرّ عليها ضوء الفن.
المتحف والمعرض كعيادة نفسية:
واحدة من الأفكار الجريئة التي يطرحها دو بوتون وآرمسترونغ هي إعادة تنظيم المتاحف والمعارض الفنية بحيث تُعرض الأعمال وفق موضوعات حياتية لا تاريخية. فبدلاً من ترتيب اللوحات بحسب القرون أو وأنواع الفنون مدارسها البصرية، يقترحان عرضها وفق حاجات الإنسان المعاصرة: قاعة للأمل والرجاء، قاعة للحزن، قاعة للتسامح، قاعة للصفاء، قاعة للخيال والأحلام وأخرى للحنين.
بهذا الترتيب، يتحوّل المتحف إلى «عيادة للجمال»، يدخلها الزائر لا ليكتسب معلومة، بل ليُشفى من ضغوط الحياة الحديثة. ففي مواجهة عمل فني يصوّر الفقد، يجد العزاء، وفي عمل يحتفي بالأمل، يجد دفعة للاستمرار.
إنها طريقة جديدة لجعل الفن أكثر قربًا من الناس، وأقلّ تعقيدًا من الخطابات النقدية التي غالبًا ما تُبعد الجمهور عن فهم الأعمال الفنية. الفن، وفق هذه الرؤية، ليس ملكًا للنقاد، بل لغةٌ مشتركة يتحدثها الجميع دون حاجة إلى ترجمان.
بين الفلسفة والعلم: أين يقف «العلاج بالفن»؟
الفكرة التي يطرحها دو بوتون وآرمسترونغ لا تُقدّم الفن كعلاجٍ طبيٍ مباشر، بل كـعلاجٍ ثقافيٍ وعاطفي، أي وسيلة لدعم التوافق النفسي والوجداني. ومع ذلك، فإن علم النفس الحديث يدعم كثيرًا من جوانب هذه الرؤية. فقد أثبتت دراسات متزايدة أن ممارسة الفنون أو التأمل في الأعمال الفنية يمكن أن تخفف من القلق والاكتئاب وتحسن المزاج العام.
لكن المؤلفين لا يقدمان وصفة سريرية بقدر ما يقدمان دعوة للتأمل: أن نجعل الفن جزءًا من حياتنا اليومية، لا أن نحصره في المتاحف والمعارض أو في الكتب. إن مشاهدة لوحة أو الاستماع إلى قطعة موسيقية قد لا تشفي مرضًا، لكنها تُحدث ما هو أهمّ: تُعيد للإنسان إحساسه بالانسجام مع ذاته.
الفن هنا يشبه الصديق الذي لا يُعطي حلولًا، بل يصغي بصمتٍ عميق، فيخفّف عنا بعض الألم بمجرد حضوره.
نقد وتوازن:
رغم أن فكرة «الفن كعلاج» تلقى إعجابًا واسعًا في الأوساط الثقافية، إلا أن بعض النقّاد يرون فيها تبسيطًا لتجربة الفن. فحين نحصر وظيفة الفن في العلاج أو المنفعة، قد نفقد جزءًا من قيمته الجمالية والرمزية. الفن لا يمكن أن يُختزل في وظيفة واحدة، لأنه بطبيعته مفتوح على التأويل.
غير أن قوة هذا المشروع تكمن تحديدًا في أنه لا يدّعي احتكار المعنى. بل يقدّم رؤية موازية تجعل الفن أكثر إنسانية، وأكثر قدرة على التواصل مع المتلقي العادي. فبدلاً من أن يظل الفن حكرًا على الأكاديميين والنقّاد، يقدّمه المؤلفان كصديقٍ مشترك لكل إنسان يشعر بالوحدة أو القلق أو الحنين.
الفن كبوصلة للحياة:
من أجمل ما في كتاب «الفن كعلاج» أنه يُعيد الاعتبار للجانب العاطفي في تجربة الفن. فالفن، كما يقول المؤلفان، «ليس ترفاً للحالمين، بل خريطة تساعدنا على العيش بذكاء أكبر». إنه يعلّمنا كيف نعبّر عن أنفسنا حين تعجز الكلمات، وكيف نجد المعنى في الأشياء الصغيرة: في ضوء نافذة، أو في ظلّ شجرة، أو في وجهٍ نُحبه ونخاف أن نفقده.
إن إدراك الجمال ليس هروبًا من الواقع، بل طريقة لمواجهته بجرأة وحنان في آنٍ واحد. فالفن لا يغيّر العالم خارجيًا، لكنه يغيّر نظرتنا إليه، وهذه النظرة وحدها كفيلة بأن تُبدّل كل شيء.
نحو ثقافة تُشبهنا:
إذا أخذنا أفكار دو بوتون وآرمسترونغ بجدية، يمكننا إعادة النظر في علاقتنا بالفنون العربية المعاصرة، وبالتراث البصري الإسلامي والعالمي. يمكن للفن في العالم العربي أن يلعب دورًا علاجيًا في مجتمعاتٍ تعاني من ضغوط سياسية واقتصادية ونفسية متراكمة.
تخيّل لو أن المتاحف والمعارض العربية نظّمت قاعاتها على طريقة «الفن كعلاج»: قاعة للحب في زمن الغربة، قاعة للسلام في زمن الصراع، قاعة للأمل في وجه الخسارة، قاعة للإيثار والكرم بدل الأنانية والغيرة، قاعة للسماحة بدل الكراهية، سيصبح الفن عندها وسيلة للتربية والترقية الوجدانية لا مجرد عرض للتاريخ والحركات.
كما يمكن للفنانين المعاصرين أن يتبنّوا هذا المنظور في أعمالهم، فيجعلوا من لوحاتهم ورسوماتهم ورسائلهم البصرية أدوات لتضميد الذاكرة الجماعية ورفعتها، ومساعدة الأفراد على التوازن الداخلي. فالفن الذي ينطلق من الألم يمكن أن يكون بذرة شفاء.
خاتمة: الجمال علاج الروح
ما يقدّمه ألان دو بوتون وجون آرمسترونغ ليس نظرية جمالية جديدة فحسب، بل فلسفة للحياة. إنهما يقولان لنا ببساطة إن الفن ليس رفاهية، بل ضرورة. ليس ميداناً للنخبة، بل علاجاً للإنسانية بأسرها.
وحين نقف أمام لوحة أو منحوتة أو عمل بصري، لنتذكّر أن الفن لا ينتظر منا أن نُحلّله أو نحكم عليه، بل أن نسمح له أن يعمل فينا، أن يُعيد ترتيب أفكارنا، وأن يربط بين هشاشتنا وقوة الجمال فينا.
الفن، في نهاية المطاف، لا يعالج الحقد والكُره والحسد، لكنه يُصلح الروح. والروح هي التي تجعل الحياة ممكنة، مهما كانت قاسية.